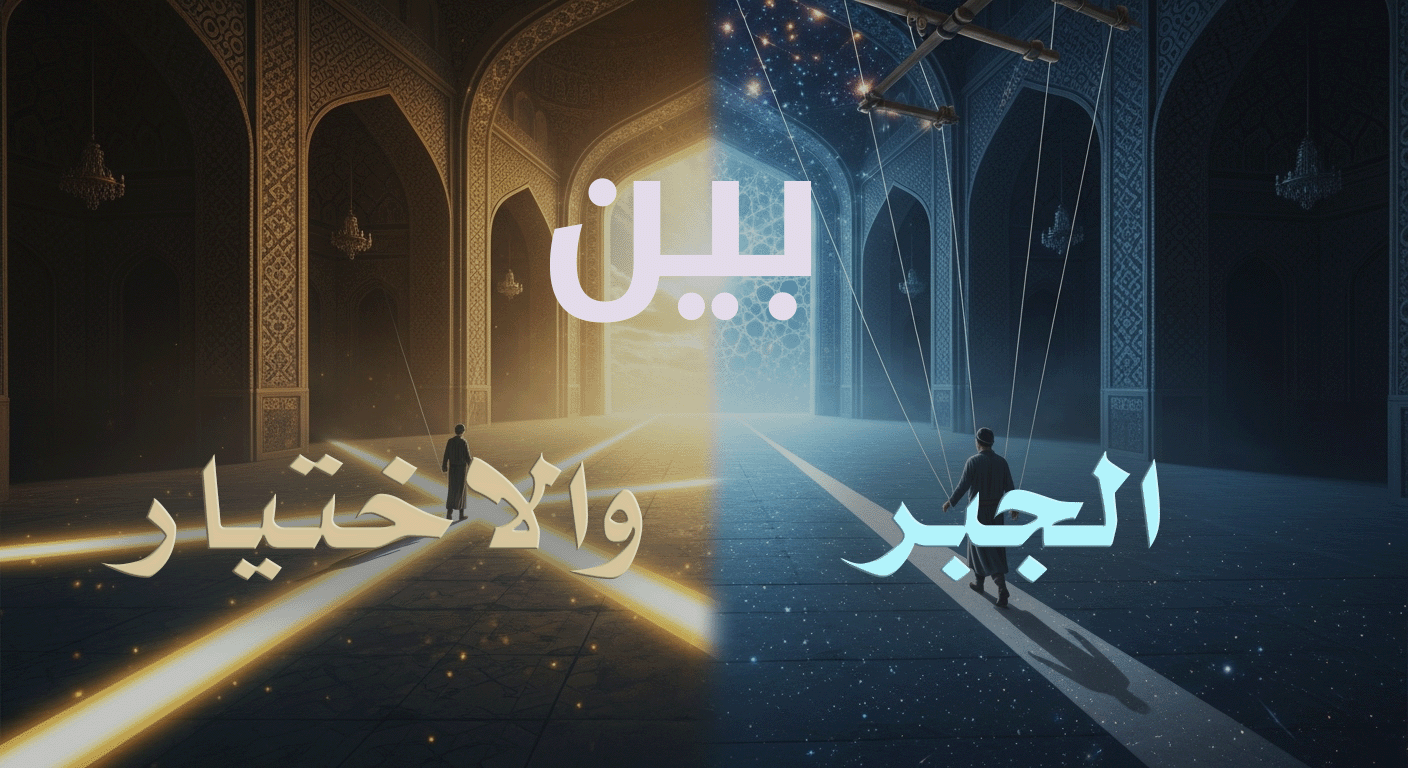الاستثناء القرآنيّ لمن ينتمي إلى المعاهدين: حمايةٌ للدماءِ وتأسيسٌ للسّلامِ
18 أبريل، 2024
607
{إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 90]
الاستثناء القرآنيّ لمن ينتمي إلى المعاهدين: حمايةٌ للدماءِ وتأسيسٌ للسّلامِ
وهل يكون المسلم معاهدا؟
ينير القرآن الكريم دروبنا بنوره، ويهدي أرواحنا بحكمه، ويرسي قواعد السلام الشامل في رحابه. وتمثل آية {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق}
أنموذجا رائعا لفهم مفهوم السلام في الإسلام، وكيف يؤسس هذا الدين الحنيف لحماية الدماء، وضمان الأمن والأمان للجميع.
ففي ظلال قوله تعالى {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} [النساء: 89] جاء بعدها قوله {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}
فاستثنى من إعلان العداوة الحربية، ومن عدم اتخاذ الولي والنصير من يصل إلى المعاهدين ويُبَصِّرُنا بذلك قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}، فكلمة ﴿ﮟ﴾ تدل على الاستثناء من إعلان العداوة الحربية، وعدم اتخاذ الولي والنصير فئة وصفها القرآن بمن يصل إلى المعاهدين، ومعنى ﴿يَصِلُونَ﴾: يتصلون، وعداها بـ ﴿إِلَى﴾؛ ليضمنها معنى: ينتسبون، أي: يتصلون بمن عاهدتموهم، أو ينتسبون لهم بالرحم أو الانتماء الوطني أو غيره:
هنا قد تعارض الفكرة بمجرد قراءتك للكلمات الأولى، وربما أعرضت ونأيت بجانبك، وقلت: وهل هذا يعقل؟ المعاهد لفظ يطلق في الحديث النبوي، وعند فقهائنا في المشهور على غير المسلم بشروط، فكيف تجعل مسلمًا معاهدًا؟
فأقول لك: إنه القرآن المجيد وبصائره.. تسع الآفاق كلماته، تقرأه في العصور الخالية، والأجيال الحاضرة والباقية، فتجده يقدم لك الحلول، وينير بصائرك مهما اسودت الدروب وأظلم الطريق.. والآن أخبرني: ألا ترى أن الواقع متخم بالمتغيرات المثيرة؟
لقد تخلت بعض الأنظمة التي تنتسب شعوبها إلى الإسلام عن بصائر الإسلام الأساسية في الواقع الإنساني، والعلاقات الدولية، وحصرته في العبادات الشعائرية، وبعض الأحوال الشخصية والاجتماعية، وبذا فإنك ترى إمكانية الحروب بين هذه الأنظمة وإعلان حالة العداوة والبغي دون سابق إنذار، وتجر إليها في ذلك الشعوب رغمًا عنها، والآيات التي نحاول تفيؤ ظلالها تمدنا بالبصائر الهادية، والآن عد بنا إلى هذا الصنف:
هذه الآية تفصل شيئًا عظيمًا يقع في النفوس، فقد سبق في الآية السابقة أن أخبرنا الله عن المنافق الذي يجب أن يصنف ضمن العدو الحربي، فيصدق فيه قول الله تعالى ذكره: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا }، وحتى لا يغلو أحدٌ في تطبيق تلك الآية، ولا يتخذها المتطرفون شعارًا لهم يتلاعبون بها، ويخدعون بها عقول الشباب، فيتسرعون في قتل الآخرين ويزعمون أنهم منافقون جاءت هذه الآية في موضعها المنطقي لتبصير العقول، ولتمد العالم بالرعاية الإلهية التي تُفَصِّل أحداث العالم كما ينبغي أن تكون..
ما أكثر ما تسمع هذه الأيام عن المصائب الكبرى التي يتم إلصاقها بالإسلام عمدًا وجهلًا إما من الغلاة المسلمين الذين يقتلون إخوانهم بالتخرص واتباع الظن والأهواء الشيطانية، وإما من المتعصبين غير المسلمين الذين يتلاعبون بهذه القضية، فما الذي يعصم الدماء؟
هنا يبين ذلك الله سبحانه وتعالى أن مدار الحياة قائم على إلقاء السلم، فإلقاء السلم وعدم التعاون مع المحاربين، وكف الأيدي أساس العلاقات الداخلية والخارجية في الإسلام، فإن الكافر قد يعيش بين المسلمين، وكذلك المنافق، والذي في قلبه مرض، والعكس فقد يعيش المسلم معهم.. فما مدار الأمر في حماية الأمن؟ إنه إلقاء السلم، سواء أكان من منافق أم من كافر، أم من عاص، فقوله تعالى ذكره: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} إلا هنا استثناء من قوله – عزَّ جارُه: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (النساء: 89) .
فمعنى ﴿ يَصِلُونَ﴾ يتصلون وعداها بـ﴿ إِلَى﴾ ليضمنها معنى ينتسبون، أي: يتصلون بمن عاهدتموهم أو ينتسبون لهم بالرحم أو الانتماء الوطني أو القبلي أو غيره، فهؤلاء ينتمون إلى المعاهدين سواء أكانوا مسلمين أم لا، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت اتفاقية عهد بينه وبين كفار قريش، ودخل في اتفاقية قريش بنو بكر، فهم لم يوقعوا اتفاقية مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما في نص الاتفاقية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وأن من والاهم ولحق بهم فله حكمهم، أي: لهم الصلاحية ليضموا غيرهم إليهم، فهم عندما ينتمون إلى هؤلاء الذين بيننا وبينهم عهد فهم يصيرون في حكمهم، فيجب على قريش أن يمنعوهم من أن يعتدوا على المسلمين، فقريش هم الطرف الضامن لهؤلاء الذين لم يكن بيننا وبينهم اتفاقية مباشرة.
والمعنى -كما يقول الطبري-: «فإن تولىَّ هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله، وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، سوى من وَصل منهم إلى قومٍ بينكم وبينهم مُوادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم، وصاروا منهم، ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيًا بحكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم..» [1] أن تسالموه، وهو في ذمة الله، والله قد عصمه فلا سبيل لكم عليه.. وهذه الآية تؤكد المبدأ الذي جعلناه عنوانًا للمحور، وهو أن الإسلام يؤسس معنى السلام الشامل، وأن القتال في الإسلام سببه الاعتداء المسلح من الآخرين بغض النظر عن دينهم، حتى لو كانوا مسلمين، وهنا يزين الرازي مجلس تدبرنا القرآني بهذه اللفتة الإيمانية الممتلئة رجاء وحسن ظن بالله، فيقول: «وَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ بِشَارَةً عَظِيمَةً لِأَهْلِ الإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا رَفَعَ السَّيْفَ عَمَّنِ التَجَأَ إِلَى مَنِ التَجَأَ إِلَى المُسْلِمِينَ، فَبِأَنْ يَرْفَعَ العَذَابَ فِي الآخِرَةِ عَمَّنِ التَجَأَ إِلَى مَحَبَّةِ اللَّه وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ كَانَ أَوْلَى» [2].
[1] تفسير الطبري ت شاكر (8/ 19).
[2] تفسير الرازي (10/ 171).




 الرئيسية
الرئيسية 

 الخطب
الخطب 
 مجالس أهل التفسير
مجالس أهل التفسير