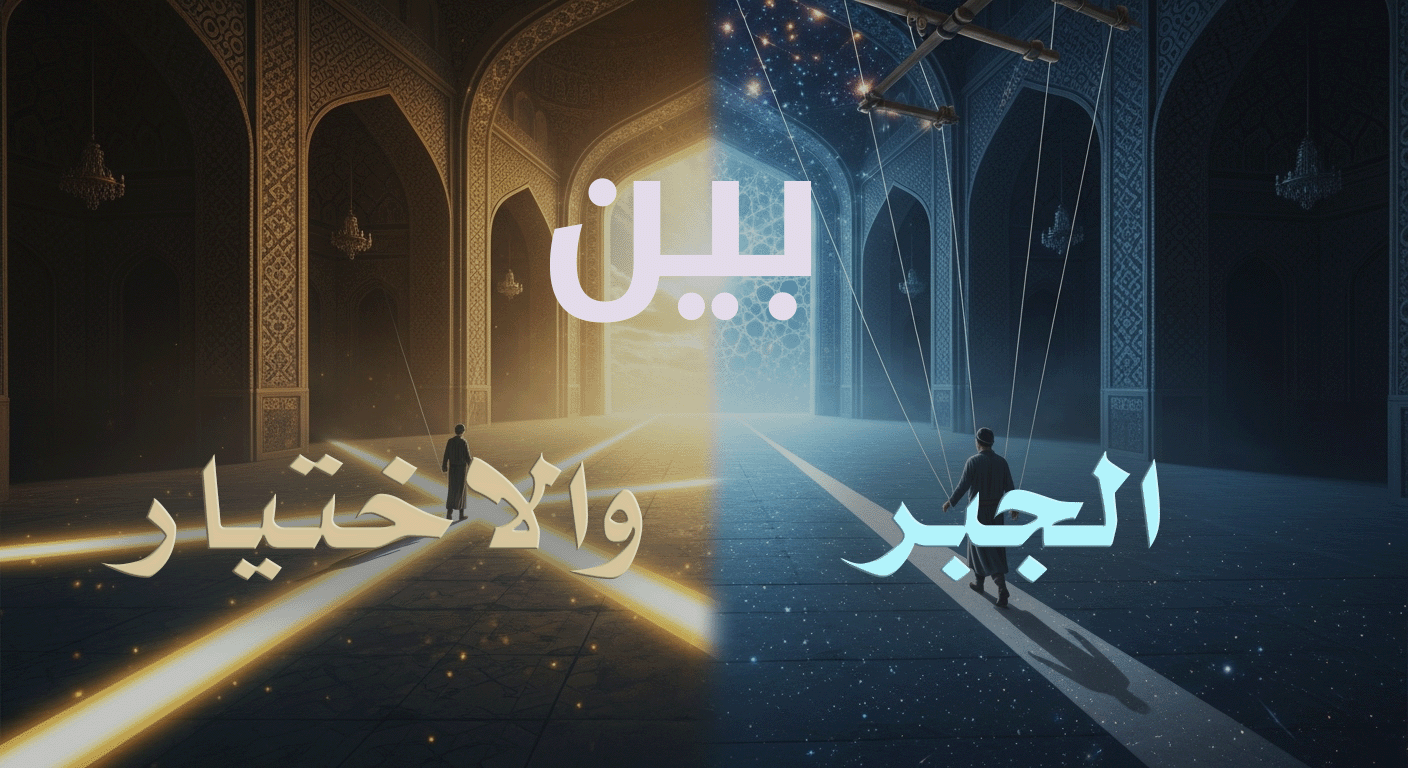رمضان… الصيام والتراويح
4 أبريل، 2024
493
د. عبدالله محمد البكاري الخديري
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحابته أجمعين، أما بعد:
فإن شهر رمضان له نكهة، ومذاق خاص يُميزه عن سائر الشهور؛ حيث إن فيه من الخصائص والمميزات التي تجعله رائدًا في الروحانية واتصال الروح بالسماء، وكأنه حبل ممدود يَعسُر قطعه ما دام متصلًا بالسماء، ولهذا نجد النفوس في رمضان أقرب إلى اللين والهدوء والسكينة، ونجد الطمأنينة كلما اقتربنا من النصف الأخير منه، وله أسباب كثيرة لعل أبرزها نزول القرآن الكريم فيه؛ حيث هو جوهر السعادة والطمأنينة المنشودة، وكذلك ارتباط هذا الشهر بالصيام، وهو ما يُميزه عن غيره كونه لا رمضان إلا بصيام بخلاف غيره من الشهور، ولذلك فإن القرآن والصيام متلازمان لا ينفكان في هذا الشهر الكريم، فهما يحركان المشاعر نحو الجد، واليقظة نحو العبادات الأخرى؛ كالتراويح والإنفاق، وغير ذلك.
والصيام باعتبار كونه مأمورًا به، أو منهيًّا عنه ينقسم قسمين:
الأول: الصيام المأمور به شرعًا، وهو قسمان:
أ- الصيام الواجب، وهو على نوعين:
- واجب بأصل الشرع؛ أي بغير سبب من المكلف، كصوم شهر رمضان.
- وواجب بسبب من المكلف؛ كصوم النذر، والكفارات، والقضاء.
ب- وأما الصيام المستحب وهو صوم التطوع، فينقسم قسمين:
- الأول صيام التطوع المطلق، وهو ما جاء في النصوص غير مقيَّد بزمن معين؛ كصيام أي يوم من أيام العام غير أيام الحرمة والكراهة.
- والثاني صيام التطوع المقيد، وهو ما جاء في النصوص مقيدًا بزمن معين؛ كصوم يومي تاسوعاء وعاشوراء، ويوم عرفة، والاثنين والخميس، والست من شوال…
الثاني: الصيام المنهي عنه شرعًا ينقسم قسمين:
1- صيام محرم؛ مثل صوم يومي العيدين.
2- صيام مكروه؛ مثل صوم يوم عرفة للحاج.
- وأما الصيام باعتبار تهذيب النفس وتقويمها والعناية بها، فقد قسَّمه الإمام الغزالي إلى ثلاث درجات، صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص، أما صوم العموم، فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة، وأما صوم الخصوص، فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام، وأما صوم خصوص الخصوص، فصوم القلب عن الصفات الدنية، والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية.
وللصيام فضائل كثيرة وغايات كبيرة؛ منها:
- أن الله تعالى أضافه إلى نفسه، فقال: (الصوم لي وأنا أجزي به).
- ومنها أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
- ومنها أن الصوم جنة وحصن من النار.
- ومنها أن الصيام كفارة للذنوب والخطايا.
- ومنها أن الإكثار من الصوم سبب لدخول الجنة.
- ومنها أن الصوم تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة.
- ومنها أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة.
- ومنها أن الصوم من الأعمال التي وعد الله تعالى فاعلها بالمغفرة والأجر العظيم.
وقد تأملت كثيرًا في الحكمة من تشريع الصيام، فوجدت أن له حِكمًا كثيرة يمكن أن نجملها في ثلاث حكم رئيسة:
الأولى: تحقيق التقوى وهذه معلومة مشهورة منصوصة ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، وهي أُس الحكم وأساسها ومصدرها وأقواها، وعليها العمل والمعول.
الثانية سماوية صرفة؛ أي إنها تقوم على تقوية الصلة بعلاقة العبد بخالقه صلة الأرض بالسماء، ففي رمضان الصيام، والتراويح، وقراءة القرآن… (عبادات).
والثانية أرضية وسماوية أيضًا، فهي أرضية باعتبار الجانب الإنساني الاجتماعي والاقتصادي (معاملات)، وسماوية باعتبار الأوامر الصادرة في هذا (عبادات)، وهذا يتمثل في الإنفاق، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فيدارسه القرآن كما في الصحيح.
وهذه هي الحكمة المقاصدية والاجتماعية المهمة؛ إذ في رمضان وعند الصيام يشعر الصائم بالجوع والعطش وربما التعب، وهو بهذا يتذكر إخوانه الجائعين والمحرومين طول العام، لا يجد أحدهم طعامًا يسد به جوعه، أو ماءً نظيفًا يسد به رمقَه، أو بيتًا يأوي إليه يحتويه، ويدفع عنه حر الصيف وبرد الشتاء، فتتذكر بهذا كله أخي الصائم إخوانك وما هم عليه، فتجود نفسك بالعطايا والزكوات عسى الله أن يتقبل منك صالح الأعمال.
والحكمتان الثانية والثالثة مخرجتان طبيعيتان وحتميتان متفرعتان من الحكمة الأولى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾، وقد شرع الله الصيام لعباده رحمةً بهم، وإحسانًا إليهم، وحِميةً لهم وجُنَّة.
- وأما التراويح، فهي جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وسُميت بذلك؛ لأن الناس كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعًا استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعًا، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثًا.
والمقصود بها قيام شهر رمضان، ولها فضل عظيم؛ حيث إنها سبب لغفران ما تقدَّم من الذنوب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمُرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه”.
وكذلك حديث من صلى القيام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيام ليلة كاملة، وهذا عام في أي ليلة كانت في رمضان وغيره؛ كما جاء في حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: “قلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، حُسب له قيام ليلة”.
- وأما حكم صلاة التراويح، فهي سنة مؤكدة؛ لحديث أبي هريرة السابق، وكذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم، “فامتناعه صلى الله عليه وسلم عن الخروج للمسجد تباعًا، وكذا قوله: “إلا أني خشيتُ أن تُفرض عليكم”، دلَّت على أنها سنة هذا من حيث أداؤها، وقد نقل الإجماع على ذلك أئمة كثيرون منهم الإمامان النووي والصنعاني.
- وأما حكمها في المسجد جماعة، فهي أفضل من صلاتها منفردًا؛ لحديث عائشة المتقدم، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح جماعة في المسجد، ولم يمنعه من المداومة عليها جماعة إلا خوفه أن تفرض على الأمة، فتحصل المشقة بذلك، وحديث عبد الرحمن بن عبد القارئ، قال: “خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم إلى أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله”، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم ابن قدامة وغيره.
- وأما وقتها، فالسنة أن تصلى بعد العشاء الآخرة لاتفاق العلماء سلفًا وخلفًا.
- وأما عدد ركعاتها، فقد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة في رمضان وغيره؛ كما في الصحيحين.
- وأما من قوله، فقد ورد بدون تحديد عددٍ معين منها حديثُ ابن عمر الثابت في الصحيحين أيضًا أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: “صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى”.
قال ابن تيمية: “والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد عشرين ركعة، أو كمذهب مالك ستًّا وثلاثين، أو ثلاث عشرة، أو إحدى عشرة، فقد أحسن، كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقِصره”.
وبناءً على هذا، فليس هناك قول فصل في تحديد عدد الركعات، والمسألة اجتهادية بحسب الطاقة والقدرة وطول القيام ونحوه، ولهذا قال الإمام السيوطي: “الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان، الأمرُ بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعددٍ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها…”.
وكلام العلماء في تحديد عدد ركعات التراويح مبسوط في مكانه، من أراد الاستزادة فليرجع إليه.
- وأما القراءة في صلاة التراويح، فهي أيضًا ليس لها مقدار محدد، لكننا نرى أن يقرأ الإمام المصحف كاملًا في شهر رمضان؛ حتى يسمع الناس جميع القرآن، فتحصل للإمام والمأموم ثواب القراءة والسماع؛ لأنه شهر القرآن، ولأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ولهذا يقول الإمام الكاساني: “السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح، وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمر، فهو من باب الفضيلة، وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثًا، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا، فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل، فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة”.
- وأما خصائص رمضان، فأهم خصيصة فيه هي نزول القرآن؛ لقوله قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة: 185]، وكان نزوله في ليلة القدر من رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: 1]، وقد وصف الله تعالى ليلة نزول القرآن بأنها ليلة مباركة، وذلك لبركة نزوله، فنزوله بركة وتلاوته بركة، وهدايته بركة والتداوي به بركة، وسماعه بركة وتعليمه بركة، وكله بركة، كيف لا وهو هداية لأمة عاشت الظلام والهوان، فأخرجها إلى النور وريادة الأمم.
- والخصيصة الثانية أن فيه تُفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين؛ لحديث “إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين”.
وهذه ثلاثية مهمة ومتلازمة لنجاح الصيام، وكأنها عملية إعداد استباقية، توضح الخطوط العريضة لسالكي طريق باب الريان؛ حيث فتح لك أخي الصائم وأختي الصائمة “أبواب الجنة”؛ لتشتاق نفسك وتقوى هِمتُك للهدف الذي تصوم من أجله؛ حتى يكون عونًا لك على الهدف المنشود الذي يسعى إليه كل مسلم، وهو دخول الجنة، وكفى بها من نعمةٍ!
ثم أكَّد هذا “بإغلاق أبواب النار”، حتى تعبد الله بطمأنينة وراحة بال، وتطرح القلق والاكتئاب والقنوط، خصوصًا إذا أسرف العبد على نفسه بالمعصية.
ثم التهيئة الثالثة، وهي في بداية طريق الصيام “تصفيد الشياطين”؛ حتى تتمكن من الصيام بدون عوائق وشواغل نفسية أو شهوانية، وعليه فلم يبق لك أي عذرٍ أو تكاسل أو تهاونٍ في تقوية العزيمة والإقبال على الله بالكلية؛ لتصوم صومًا يُرضي خالقك، ويريح نفسك من صراع الملذات والشبهات والشهوات.
- الخصيصة الثالثة أن العمرة فيه تَعدِل حِجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحًا ننضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة”.
وفي رواية قال: “لَما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان – تعني زوجها – كان له ناضحان، حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضًا لنا، قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي”.
- وهذا الفضل ليس مختصًّا بهذه المرأة وحدها، بل هو عام لجميع المسلمين إن شاء الله.
ومن سبق له أن اعتمر في رمضان؛ فالأفضل عندي أن يتصدق بنفقات ذلك على الفقراء والمحتاجين؛ لأن الصدقة لصاحب الحاجة مقدَّمة على نوافل العبادات، وأهم من ذلك، فلأن تُشبع جائعًا أو تكسو عاريًا، أو تداوي مريضًا خيرٌ من نوافل العبادات الأخرى، كون النفع متعديًا.
- وأما ليلة القدر وفضيلتها، فكفى بها من مكانة وعظمة أن القرآن نزل فيها ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: 1]
- وسُميت بالقدر؛ لأن الله تعالى قدر فيها كل ما هو كائن في سائر العام، ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ [الدخان: 4، 5]، ففي تلك الليلة يقدر الله مقادير الخلائق لعام مقبل، ويكتب فيها الأحياء والأموات، والناجين والهالكين، والسعداء والاشقياء…
- والفضيلة الثانية أنها ليلة مباركة ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ [الدخان: 3]، كيف لا والعبادة فيها أكثر من ألف شهر، ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: 3].
فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تعدل ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر.
- والثالثة نزول جبريل عليه السلام أمين الوحي والملائكة الكرام بإذن الله تعالى، وكفى بها من قدسية وروحانية، واتصال الأرض بالسماء، ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [القدر: 4]، فتنزل الملائكة فيها بالرحمة والمغفرة والبركة والخير، وهذه الليلة محظوظة وفيها احتفاء سماوي ملائكي رفيع القدر والمكانة والعظمة، مهمته شهود المسلمين، وحفُّهم بالرحمات والبركات، فهي كلها أمن وأمان وسلامة واطمئنان، ولذلك ختمها بقوله: ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: 5].
فهي ليلة خالية من الشر والأذى، وتكثُر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر، وتكثر فيها السلامة من العذاب، فهي سلام كلها، ولعظيم فضلها يُشرع فيها القيامُ والاعتكاف والدعاء، (ومَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه).
“من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر”.
وأما الدعاء فيها، فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني”.
ووقتها في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، وهو مذهب الشافعية وجمع من أهل العلم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “تَحَرَّوْا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان”.
“التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى”.
ولهذا بوَّب الإمام البخاري بقوله: “باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر”، لكن كثيرًا من الناس يسألون هل ليلة القدر تتنقل أم هي ثابتة؟
الذي يظهر لي أنها لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان، بمعنى أنها قد تكون مثلًا في هذا العام في إحدى وعشرين، وفي العام المقبل في خمس وعشرين وهكذا، وهذا قول عند المالكية وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وهو قول كثير من أهل العلم.
وعلامتها طلوع الشمس في صبيحتها صافية، ليس لها شعاع؛ لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: “أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها”.
وفي لفظ آخر صحيح عن أبي بن كعب أيضًا: “وأمارتها أن تطلُع الشمس في صبيحة يومها بيضاءَ لا شعاع لها”.
وهذه أصح علامة من علاماتها، لوجود الدليل الصحيح المنصوص عليه، وأما غيرها من العلامات؛ مثل كف نباح الكلاب، أو نزول المطر، أو اعتدال الجو، وسكون الريح وانشراح الصدر، وانقطاع النجم، وعذوبة البحار، وانتشار الأنوار، وغير ذلك، فلا يصح منها شيء، وإنما هو استئناس من بعض أهل العلم، إلا ما ورَد في أن ليلة القدر: “سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تُصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء”، فهذا مختلف فيه صحَّحه بعضهم كابن خزيمة وضعَّفه آخرون.
هذا والله أعلمُ، وصلى الله على نبينا محمد وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.




 الرئيسية
الرئيسية 

 الخطب
الخطب 
 مجالس أهل التفسير
مجالس أهل التفسير