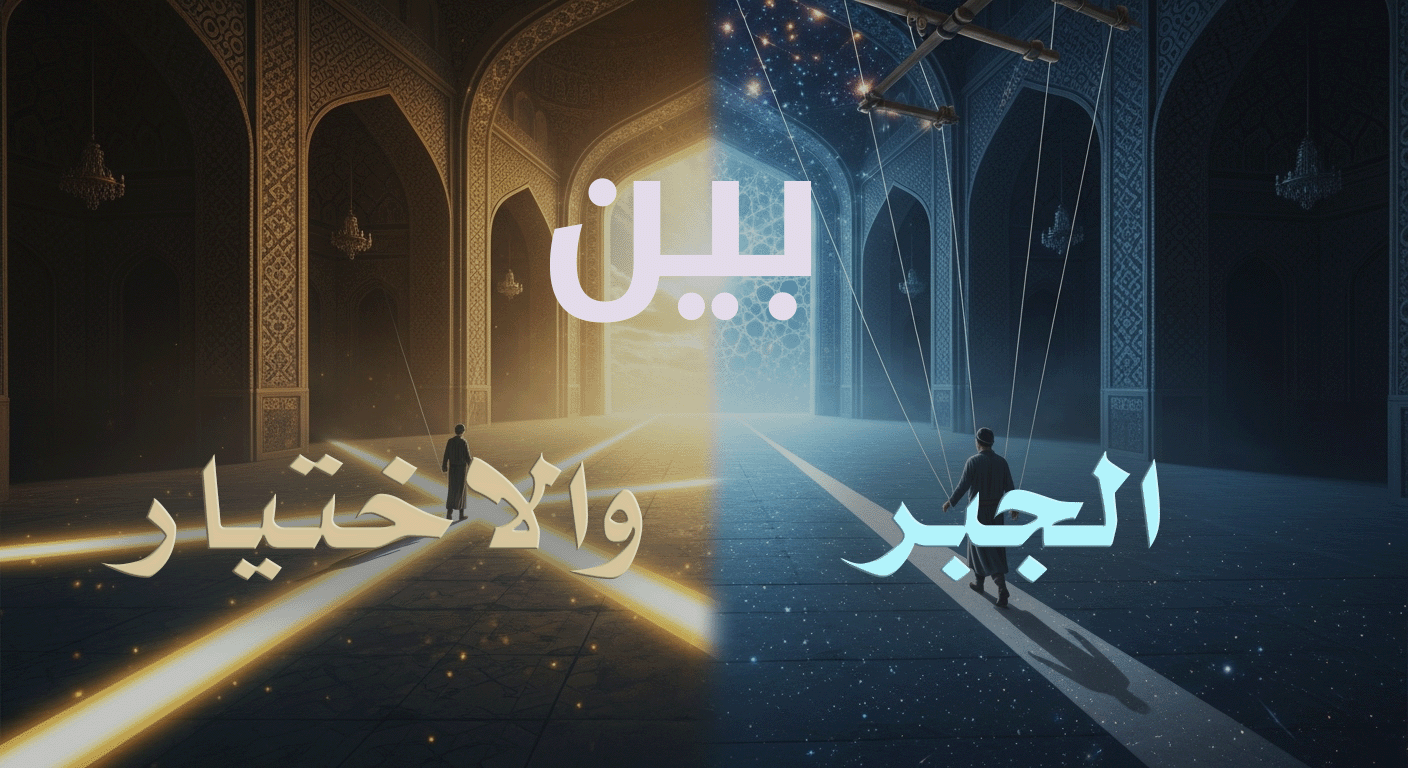الرحمة والألم
12 سبتمبر، 2021
679

عندما نصل إلى تقرير أن الرحمة مراد الله بالعالم وأنها أساس فعله ربما انبعث سائلٌ صاخبٌ قائلًا مزمجرًا: كيف تزعمون أن رحمة الله عامةٌ وأنتم تنظرون إلى الحوادث المؤلمة التي تصيب البشرية، وتبكي منها الإنسانية، سواء أكانت حوادث كونية، أم حوادث بسبب رعونة الإنسان؟
ولعلَّ من مسالك الصواب أن نطلب من صاحب السؤال أن يستمع إلى الجواب، ولا يأخذ نفسه بالضجيج الذي يصحب هذا السؤال عادةً؛ إذ إن مثل هذا السؤال كان مفتاحًا لعالم الرياضيات (جيفري لانغ Gwffery Lang) للدخول في الإسلام، وألف كتابه (الصراع من أجل الإيمانStruggling to Surrender ) وذلك بناء على تجربته التي بها أبصر نور الحقيقة في القرآن.. نعم هو تساءل كما يتساءل أي إنسان عن سر وجود الآلام في الحياة، وهل ينافي ذلك أن الله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؟
إن الرحمة هي الهدف الحقيقي من الأفعال الإلهية الكونية (الخلق) والتكاليف الشرعية (الأمر)، أما الإجابة المختصرة على السؤال فتـتضح من خلال الأمور المرتبة الآتية:
الأمر الأول: الْحَوَادِث التي تحدث للعباد قسمان:
القسم الأول: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، كالْوَالِد إذا أَهمَلَ وَلَدهُ حتَّى يفعل ما يشاءُ ولا يُؤَدِّبُهُ.
القسم الثاني: ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، كَالوَالِدِ إِذَا حبس وَلَدَهُ للعلم، والإنْسانِ إذا وقع في يده مرض الآكِلةُ (التي تسبب تآكل الجسد)، فإذا قُطعت تلك اليد فهذا في الظَّاهر عذابٌ، وفي الباطن راحةٌ ورحمةٌ.
فكل ما وجد من المصائب فهو لصالح بني الإنسان بالنظر إلى اختبار العاجلة ونتائج الآجلة، فالغافل يَغْتَرُّ بِالظَّوَاهِرِ، وَالْعَاقِلُ يَنْظُرُ إلى الحقائق ولو كانت من السَّرَائِرِ، وينظر لها بعين بصيرته: فالظواهر التي يُظنُّ أنها منافيةٌ للرحمة فحقيقتها الرحمة عند سبر أغوارها، ومعرفة حِكَمِها وأسرارها، وأقرب مثالٍ لهذا الباب قصَّةُ موسى والخضر -عليهما السَّلام-، فإنَّ موسى كان يبني الحُكم على ظواهر الأمور، وَأمَّا الخضر فإنَّهُ كان يبنِي أَحكامهُ على الحقائق والأسرار، ولذا قال لما أبان الحق، وأظهر الحِكَم والأسرار: {رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: 82].
واللافت للنظر أن هذه القصة الرائعة تمثل القدر بحذافيره؛ إذ ترى فيها الخضر عليه السلام الذي يمثل القدر الغيبي الذي لم يستطع عظيم مثل موسى عليه السلام أن يصبر عليه، وقد وصف الله الخضر بما يصلح أن يكون وصفًا للقدر {فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} [الكهف: 65]، فكلمة {عبدًا} تدل على ملك الله، وكلمة {رحمة} تدل على الأصل في أفعال الله.
إنه الأصل في قدره، وكلمة {علمًا} تدل على العلم الذي يغيب عن المشاهدة.
إن كلَّ مَا فِي العالم من محنةٍ وبلِيَّةٍ وألمٍ ومشَقَّةٍ فهو ذو حكمةٍ ورحمةٍ في الحقيقة -وإن كان عذابًا في الظَّاهر-، فوجود المصائب والحوادث يكون لحكمةٍ خاصةٍ تعود في حقيقتها إلى الرحمة:
ويكفي لبيان ذلك ذكر هذه النماذج من الأحاديث العظيمة المبينة لبعض الحِكَم من المصائب الدنيوية، فعن الأَسْوَد بن يزيد النخعي قال: دخل شبابٌ من قريشٍ على عائشة -رضي الله عنها- وهي بِمِنًى، وهم يضحكونَ، فقالت: مَا يُضْحِكُكُم؟ قالُوا: فُلانٌ خرَّ على طُنُبِ فُسطاطٍ، فكادت عُنُقُهُ أو عَينُهُ أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا؛ فإنِّى سمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: ((ما من مُسلمٍ يُشَاكُ شوكةً فما فوقها إلَّا كتبت له بها درجةٌ، وَمُحِيت عنه بها خطيئةٌ))()، وعنها -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((ما ضرب على مؤمنٍ عرقٌ قط إلا حط الله عنه خطيئة، وكتب له حسنة، ورفع له درجة)).
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يود أهل العافية يوم القيامة -حين يُعطى أهل البلاء الثواب- لو أن جلودهم كانت قُرِضَتْ في الدنيا بالمقاريض))
الأمر الثاني: التكاليف وضعت للمصلحة الإنسانية وإن كانت خلاف الأهواء والشهوات.
فهي كما قَالَ تَعَالَى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} [الإسراء: 7]، وتَركُ الخير الكثير لأجل الشَّرِّ القليل شرٌّ كثِيرٌ، فترك التكاليف لأنها تقيد الرغبات والأهواء يؤدي إلى شرور الضيق والبؤس والعناء، وانظر إلى حال الناس لو تركوا التقيد بنظام المرور لموافقة أهوائهم في السرعة كيف يكون حالهم، وكذلك الالتزام بالتكاليف الشرعية التي تكون أنظمة المرور مثلًا أحد أصغر ملامحها.
الأمر الثالث: من الرحمة خلق النار
فإن المقصود من خلقها صرف الأشرار إلى الأعمال الصالحة الإيجابية المثمرة.. إلى أعمال الأبرار. وإن وجود العقوبة الدنيوية والأخروية تساعد العصاة والفاسقين ليتركوا أعمالهم السيئة خوف العقوبة المتوقعة، وبذا يتم جذبهم أو دفعهم لا ليفكروا في العقوبة العاجلة الزائلة بل في العقوبة الآجلة التي يدوم ألمها، وتضيع الآمال في جحيم عذابها.
ها هنا ترى الخلائق يفرون إلى ربهم، ويعيدون صياغة حياتهم وفق ما يُصلح الأرض وينفع الناس، لا وفق الأنانيات الشخصية، والطمع الفردي، والحظ ذلك بصورةٍ واضحةٍ رائعةِ الترتيب، شائقة الأسلوب في سورة الليل من أولها حتى تصل إلى قوله تعالى: {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} [الليل: 14 – 18].
وهذه -أيدك الله بتوفيقه- ملامح يسيرة تبين لك شمول الرحمة، وعظمتها في التصور الإسلامي، فاشدد يديك بحبل الرحمن الرحيم؛ فقطرةٌ من رحمته تزيل كل عناء، وتجلب كل هناء، فقد وصف نفسهُ بكونه رحمانًا رحيمًا، ثمَّ إنَّه أعطى مريم -عليها السَّلام- رحمةً واحدةً حيث قال: {وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا} [مريم: 21] فتلك الرَّحمةُ صارت سببًا لِنَجاتِها من المكروهات.
أفلا يَصِير ذكر الرَّحمة في اليوم والليلة أربعًا وثلاثين مرةً -على الأقل- طُولَ العمر سببًا لِنجاة المسلمين من النَّار والعار والدَّمارِ إذا نطقوها بقلبٍ خالصٍ ويقينٍ صادقٍ؟




 الرئيسية
الرئيسية 

 الخطب
الخطب 
 مجالس أهل التفسير
مجالس أهل التفسير