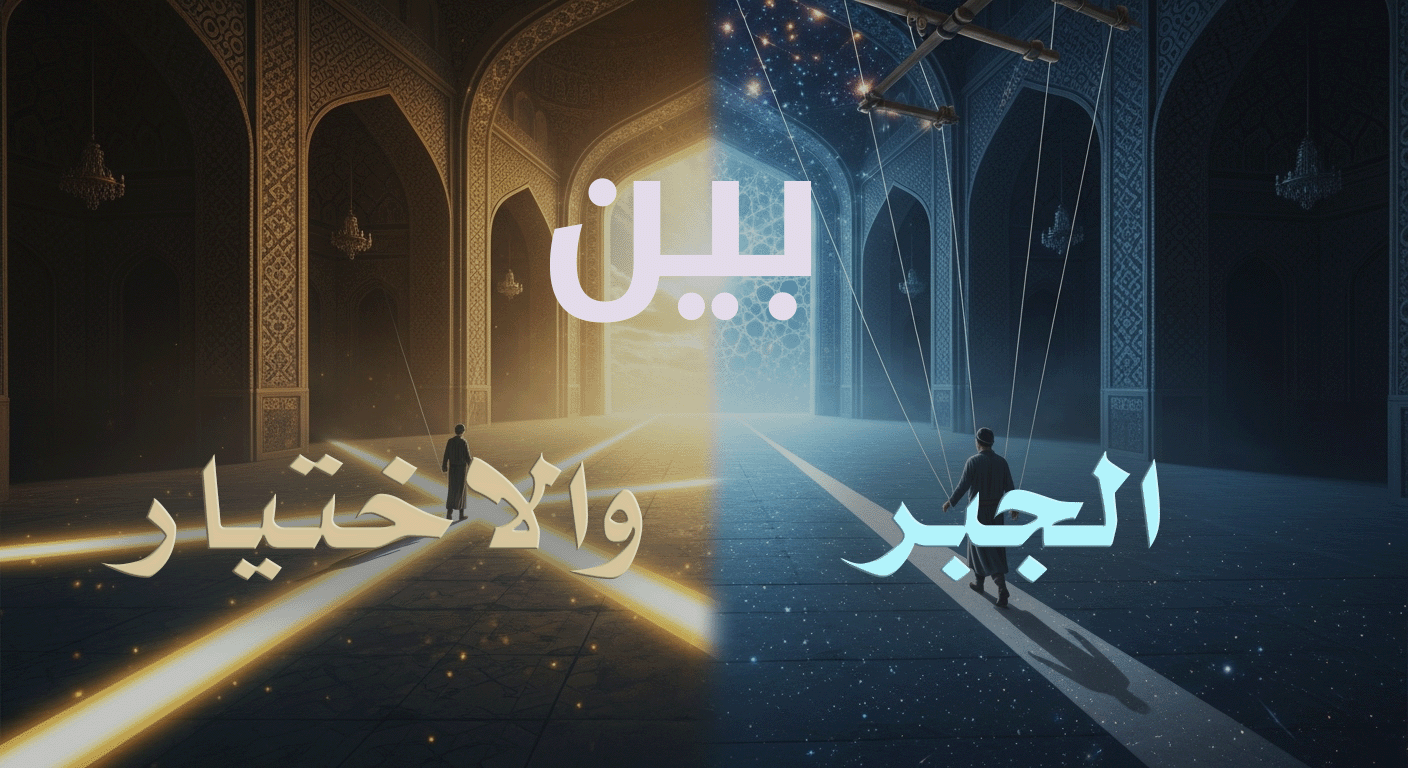أسرار البيان في اسمي الرحيم والرحمان
8 سبتمبر، 2021
5828
لعل الجمع بين اسمي الرحمن والرحيم في البسملة وفي الفاتحة وفي بعض الأدعية النبوية يحرك عقل القارئ أو السامع للقرآن فيسأل عن معنى الاسمين الكريمين والفرق بينهما وسر الجمع بينهما؟ فتعال بنا إلى معرفة ذلك:
أولا: معاني الاسمين:
ذهب العلماء إلى تفسير الاسمين مذاهب فتعددت أقوالهم وتنوعت عباراتهم.
القول الأول: الرَّحْمَنُ: هو الْمُنعِمُ بِمَا لَا يُتَصَوُّر صُدُورُ جِنْسه من العباد، وَالرَّحِيمُ: هو الـمُنعِمُ بِمَا يُتَصَوُّر جنسه من العباد.
القول الثاني: هو تعالى رحمنٌ لأَنَّه يَخلُقُ ما لا يقدر العبد عليه، رحيمٌ لِأَنَّه يفعل ما لا يقدر العبد على جِنسِهِ، فكَأَنَّه تعالى يقول: أنا رَحمنٌ لِأَنِّي أوجدتك نُطفَةً مَذِرَةً، ثم جعلتك صُورةً حسنةً، كما قال تعالَى: {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم} [غافر:64] ، وأنا رحيمٌ لأَنَّك تُسلِّمُ إليَّ طاعةً ناقصةً فأُسلِّمُ إليك جَنَّةً خالصةً.
القول الثالث: الرحمن رحمانٌ بالمسلمين والكافرين والخلق أجمعين، والرحيم زيادة اختصاص بإعطاء رحمةٍ ومَزيةٍ للمؤمنين؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب:43].
القول الرابع: اسم (اللَّهُ) يُوجِبُ وِلَايَتَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا } [البقرة: 257] ، وَاسم (الرَّحْمَن) يُوجِبُ مَحَبَّتَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} [مريم: 96] وَاسم (الرَّحِيم) يُوجِبُ رَحْمَتَهُ {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الْأَحْزَابِ: 43].
القول الخامس: قيل: الرحيم الذي يُنعم بدقائق النعم، وتفاصيلها، والرحمن ينعم بجلائل النعم، وعظائمها.
ثانياً: فصل الخطاب
وبما أنه لا يوجد دليلٍ فصلٍ يحسم بين تلك الأقوال؛ فيمكن تصحيح كل تلك المعاني؛ لأنه لا تعارض بينها، وهذا التنوع في فهم الفرق بين الاسمين يبين لنا اتساع مجالات الرحمة؛ فلم تتنوع الأوصاف لموصوفٍ واحدٍ في صفةٍ واحدةٍ إلا لتدل على عظمة هذا الوصف وغلبته وأصالته، بل ولتدل على اتساع مجالاته، فالرحمة تكون في الوسائل كما هي في الغايات، وتكون في المبادئ كما هي في العواقب، وتكون في المقدمات كما هي في النتائج، وتكون في الشرائع والنظم والشعائر والمسؤوليات كما هي في الجزاء والثواب والمكافآت، وتكون في الصغائر والخفي من المسائل، كما هي في العظائم والجلي من أمور الحياة..
و يلخص السهيلي ذلك فيقول: “وفائدة الجمع بين الصفتين {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الإنباءُ عن رحمةٍ عاجلةٍ وآجلةٍ، وخاصةٍ وعامةٍ”، و سئل أَبَو الْعَبَّاسِ بْنُ عَطَاءٍ: إِلَامَ تَسْكُنُ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ؟ قَالَ: إِلَى قَوْلِهِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]؛ لِأَنَّ فِي بِسْمِ اللَّهِ هَيْبَتُهُ، وَفِي اسْمِهِ الرَّحْمَنِ عَوْنُهُ وَنُصْرَتُهُ، وَفِي اسْمِهِ الرَّحِيمِ مَوَدَّتُهُ وَمَحَبَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي فِي لَطَافَتِهَا فِي هَذِهِ الْأَسَامِي فِي غَوَامِضِهَا”.
وهذان الاسمان العظيمان يدلان على صفتين عظيمتين إذا افترقا اجتمعتا، وإذا اجتمعا افترقتا، فإذا ذُكِر أحدهما فقط دل على المعنى الذي في الآخر، وإذا ذُكِرا معًا دلَّ كل منهما على معنى ًخاصٍّ به.
وهنا قد تسأل -عمر الله أيامك بالسعادة والعبادة- لماذا قدَّم الله اسمه (الرحمن) على اسمه (الرحيم)؟ ولعل الجواب يكمن في أن الله حرَّم على الناس أن يَتَسَمَّوا ببعض أسمائه كالرحمن والخالق بخلاف غيرها من الأسماء كالسميع والبصير، فقدَّم الاسم الخاص به دون جميع خلقه، ليعرف السامعُ مَنْ تَوجَّه إليه الحمد والتمجيدُ، ثم يُتبع ذلك بأسمائه التي قد تَسمّى بها غيرُه، وبذا تشيع الرحمة بين الخلق، فكل من رَحِمَ انسكبت عليه رحمـــــةٌ تملأ حياتَه، وتبارك أوقاتَه وأقواتَه، وقد أنشد أبو القاسم بن عساكر في ذلك فقال:
بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنمَا … ولا تكن من قليل العـــرف محتشمَـــا
واشكر لمــولاك ما أولاك من نِعمٍ … فالشكر يستوجب الإفضال والكرما
وارحـم بـقـلـبـك خـلـق الله وارعهم … فـإنـمــا يـرحـم الـرحـمـــن مـن رحـمـا
إن التَكرار الذكريُّ لهذين الوصفين العظيمين يزيد في الشعور الغامر برحمة الله في عقل المسلم بالتكرار الفعلي؛ إذ يكرر المسلم قراءة هذين الوصفين الجليلين أربعًا وثلاثين مرة في اليوم في الصلوات الخمس، فيملأ ذلك عقله وقلبه بشعورٍ مفعمٍ بعَظَمة التَصَوُّر الإسلامي للرحمة، فالرحمة أساس التشريعات والنظم الإسلامية، وهدف تطبيقاتها، فرسالة المسلمين في العالم خلاصتها الرحمة، وفي سورة (الأنبياء) ذكر الله قصص الأنبياء: إبراهيم، وموسى، وعيسى وغيرهم -عليهم الصلاة والسلام-، ثم بين الله خلاصة رسالة الإسلام التي جاء بها كل الأنبياء، ومنهم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
والرحمة (للعالَم) أعظمُ من الرحمة (بالعالَم)؛ لأن هذا التعبير {رحمة للعالمين} يقتضي نشر الرحمة بين أجزاء العالم المليئة بالظلم والفساد والقسوة، لتكون الرحمة ثقافة العالم، وطبيعته ؛ ولذا فإن من أعظم ما تُبَيِّنُه البسملة أن “العقيدة الإسلامية رحمةٌ، رحمةٌ حقيقية للقلب والعقل، رحمةٌ بما فيها من جمالٍ وبساطة، ووضوحٍ وتناسقٍ، وقربٍ وأنسٍ، وتجاوبٍ مع الفطرة مباشرٍ عميقٍ”()، فالشرع إنما وضع للمصلحة الإنسانية، والرحمة بعامة البشرية، وما وجد فيه من تكاليفَ شاقِّةٍ -كالحدود- فهي تعود في أصلها إلى الرحمة، والحفاظ على الحياة كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة} [البقرة: 179]، ومن ذلك قول الشاعر:
فقسا ليزدجروا، ومن يك راحمًا * * فليقسُ أحيانا على مَنْ يُرحمُ
ولله المثل الأعلى؛ إذ من رحمته بخلقه أن جعل العقوبة على المجرم ليكفَّ عن إجرامه، وإفساده في الأرض، ومن رحمته بالبشرية أن أزال عناصر الإفساد بينهم بحكمته.
وبعد هذا نسأل بوضوحٍ: لماذا يُصِرُّ المعاندون والجاهلون وأبواق الإعلام الحاقد على التخويف من النظم التشريعية في الشريعة الإسلامية، وهي لم تنزل إلا رحمةً بالخلق، وحرصًا على مصالحهم؟ لماذا يفر الناس مما فيه مصلحتهم وراحتهم وسعادتهم؟.
لا نبالغ إن قلنا: إن من يُنَفِّر من الشريعة، ويستخدم الإرهاب الإعلامي لصد الناس عنها إنما يحاول تدمير حقوق الإنسان ومصالحه، ويسعى كي يبغي الحياة عوجًا، ويُدَمِّرُ أجملَ الفرص التي أُتيحت للناس للحصول على السعادة.
وهناك معنى آخر لتكرار وصف الله بالرحمة يتضح منه سعة الرحمة الإلهية لتشمل الدنيا والآخرة؛ فأنت ترى أن الله ذكرهما في الآية الأولى (البسملة) قبل ذكر العالمين (الحياة الدنيا) ليؤكد على غلبة الرحمة في صفاته قبل خلق العالمين (الحياة الدنيا)، وذكرهما في الآية الثالثة قبل ذكر يوم الدين في قوله {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] (الحياة الأخرى) ليبين أن الرحمة هي الغالبة في حساب يوم الدين في الآخرة، ويتآزر ذلك لبيان إرادة الله الرحمة بالكون والخلق؛ إذ ذكرها قبل ذكرهم وبعد ذكرهم.




 الرئيسية
الرئيسية 

 الخطب
الخطب 
 مجالس أهل التفسير
مجالس أهل التفسير